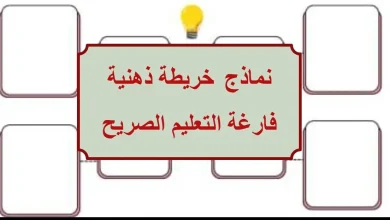أهداف التعليم في المرحلة الابتدائية في المغرب
تحليل شامل لأهداف التعليم في المرحلة الابتدائية في المغرب حسب الإصلاحات الوطنية والكفايات العالمية
يقدم هذا التقرير تحليلاً شاملاً لأهداف التعليم الابتدائي في المغرب، بدءًا من مرحلة التعليم الأولي وصولاً إلى الصف السادس الابتدائي. يهدف التقرير إلى تفصيل هذه الأهداف ضمن أبعادها المعرفية والمهارية والقيمية، مع تسليط الضوء على كيفية تشكيلها وتأثرها بالإصلاحات التعليمية الوطنية الرئيسية، لا سيما “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” و”القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”. يؤكد التقرير على التزام المغرب بتنشئة مواطن متكامل ومجهز بالكفايات الأساسية لمواجهة تحديات المستقبل، مع الاعتراف بضرورة معالجة الفجوات القائمة بين الأهداف الطموحة والتطبيق العملي.

أهداف التعليم في المرحلة الابتدائية في المغرب
1. مقدمة
نظرة عامة على نظام التعليم الابتدائي المغربي:
يخضع نظام التعليم في المغرب حاليًا لإصلاحات جوهرية تهدف إلى تعزيز الجودة الشاملة وإمكانية الوصول إليها على جميع المستويات. يُعد التعليم الابتدائي مرحلة تأسيسية حاسمة، مصممة لتزويد الطلاب بالمعارف والمهارات والقيم الأساسية.1 يهدف النظام بشكل عام إلى إعداد الطلاب بفعالية للمراحل التعليمية اللاحقة (الإعدادي والتأهيلي) وتعزيز اندماجهم الناجح في المجتمع والحياة المهنية.2
سياق الإصلاحات التعليمية الأخيرة وأهميتها:
أطلق المغرب سلسلة من الإصلاحات الطموحة، أبرزها “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي” و”القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.3 تُعد هذه الإصلاحات محورية في معالجة التحديات التعليمية القائمة منذ فترة طويلة، وتحسين مخرجات التعلم، ومواءمة نظام التعليم الوطني مع المتطلبات العالمية المعاصرة والتطلعات التنموية الوطنية.1 تؤكد هذه الإصلاحات على مبادئ مثل الإنصاف، والجودة للجميع، ودمج المقاربات البيداغوجية الحديثة.3
الغرض من التقرير ونطاقه:
يهدف هذا التقرير إلى تفصيل أهداف التعليم الابتدائي في المغرب، بما في ذلك التعليم الأولي والسنوات الست للتعليم الابتدائي. سيصنف التقرير هذه الأهداف إلى أبعاد معرفية ومهارية وقيمية، مقدمًا تحليلاً منظمًا وشاملاً. كما سيحلل التقرير كيفية تشكيل هذه الأهداف وتوافقها مع السياسات التعليمية الوطنية المذكورة آنفًا، وتأثيرها المقصود على التنمية الشاملة للمتعلم.
يشير التركيز الواضح على “الرؤية الاستراتيجية 2015-2030″ و”القانون الإطار 51.17” ليس فقط كمبادئ توجيهية عامة، بل كتأثيرات مباشرة على أهداف المناهج الدراسية 3، إلى نهج مركزي وتصاعدي للإصلاح التعليمي في المغرب. هذا يعني أن التغييرات على مستوى السياسة تهدف إلى أن تترجم مباشرة إلى أهداف محددة في الفصول الدراسية وممارسات تدريسية، سعيًا لتحقيق التماسك المنهجي. يهدف هذا النهج المركزي إلى ضمان التوحيد والاتساق في المعايير التعليمية على مستوى البلاد، مما قد يسهل الإصلاحات واسعة النطاق وتخصيص الموارد. ومع ذلك، قد يطرح هذا النهج أيضًا تحديات فيما يتعلق بالقدرة على التكيف مع السياقات المحلية المتنوعة أو الاندماج السريع لأساليب التدريس المبتكرة من القاعدة.
2. الركائز الأساسية للتعليم الابتدائي المغربي
2.1. الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي:
تُعد هذه الرؤية، الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بمثابة خارطة طريق شاملة لإصلاح المنظومة المدرسية المغربية للفترة من 2015 إلى 2030.3 وهي تمثل استجابة لمطلب مجتمعي ملح للإصلاح والتجديد التربوي.3
الغايات الكبرى للرؤية الاستراتيجية:
تُبنى الرؤية على ثلاث غايات رئيسية:
- بناء مواطن متكامل التكوين: تهدف إلى تنشئة متعلم مغربي مستقل، متوازن، ومنفتح، متجذر في الثوابت الدينية والوطنية والمؤسساتية. يشمل ذلك معرفة دينه وذاته ولغته وتاريخ وطنه وتطورات مجتمعه، مع الانفتاح على إنتاجات الفكر الإنساني واستيعابها وفهم تحولات الحضارات الإنسانية وتطورها.1
- تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص: يتضمن هذا البعد ضمان الولوج العادل للتعليم للجميع، وإلزامية التعليم الأولي وتعميمه، ومنح تمييز إيجابي للمناطق القروية وشبه الحضرية وتلك التي تعاني من الخصاص، وتأمين الحق في التعليم للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة.3 كما تسعى الرؤية إلى تمكين المتعلمين من استدامة التعلم وبناء مشروعهم الشخصي واندماجهم.3
- ضمان الجودة للجميع: يركز هذا المحور على تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وهيكلة مكونات المدرسة وأطوارها بشكل أكثر انسجامًا ومرونة، ومأسسة الجسور بين مختلف أطوار وأنواع التربية والتكوين. كما يؤكد على تطوير نموذج بيداغوجي قائم على التنوع والانفتاح والنجاعة والابتكار، وإتقان اللغات، والنهوض بالبحث العلمي والتقني والابتكار، وتحقيق حكامة ناجعة للمنظومة.3
- الارتقاء بالفرد والمجتمع: يهدف هذا البعد إلى مواءمة التعلمات والتكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل، وتعزيز الاندماج السوسيوثقافي، وترسيخ مجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة، وتأمين التعلم مدى الحياة، والانخراط الفاعل في اقتصاد ومجتمع المعرفة.3
المبادئ الأساسية الموجهة لتطوير المناهج:
تدعو الرؤية إلى اعتماد مقاربة الكفايات، مع التأكيد على دمج القيم، وضمان الاستمرارية والتدرج عبر الأسلاك التعليمية.1 كما تشجع على التفكير النقدي، والمبادرة، والإبداع، والتفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي، واحترام البيئة الطبيعية والتراث الثقافي والحضاري المغربي.1
2.2. تأثير القانون الإطار 51.17:
يوفر هذا القانون الإطار الشامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب.5 ويُعد بمثابة الدعامة التشريعية للرؤية الاستراتيجية 2015-2030.5
التركيز على تعزيز الجودة والتعليم الإلزامي:
يؤكد القانون صراحة على أهمية تحسين جودة التعليم وضمان إلزاميته.5 ويهدف إلى تحقيق “نقلة نوعية” في الإصلاح التربوي.3
مأسسة التعليم عن بعد:
تُعد المادة 33 من القانون الإطار 51.17 ذات أهمية خاصة، حيث تنص على أن التعليم عن بعد يجب أن يكون مكملاً للتعليم الحضوري.5 وقد كانت هذه رؤية استشرافية أثبتت أهميتها خلال جائحة كوفيد-19، مما يسلط الضوء على قدرة القانون على التكيف. يهدف القانون إلى تحويل الفصول الدراسية التقليدية إلى فصول افتراضية ودمج الوسائط التكنولوجية الحديثة لتعزيز جودة التعلم.5
الدعم المالي والحكامة:
يقترح القانون أيضًا إنشاء صندوق خاص، بتمويل من الجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمة القطاع الخاص، لدعم تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته.6 كما يؤكد على أهمية الحكامة الفعالة، والمساءلة، والمشاركة النشطة لجميع الفاعلين التربويين.3
يُلاحظ أن التركيز المستمر والشامل على مصطلحات مثل “مواطن متكامل التكوين”، و”تكوين متكامل”، و”الارتقاء بالفرد والمجتمع” 1 عبر هذه الوثائق التأسيسية يشير إلى أن التعليم المغربي لا يركز فقط على المخرجات الأكاديمية أو الاقتصادية. بل هو ملتزم بعمق بتنمية القيم الأخلاقية والاجتماعية والمدنية. هذا يعكس فلسفة إنسانية ووطنية تدعم المناهج بأكملها، وتهدف إلى تعزيز التماسك الوطني والمرونة من خلال إعداد مواطنين ليسوا فقط مهرة، بل أيضًا متجذرين ثقافيًا ومسؤولين اجتماعيًا.
إن مأسسة التعليم عن بعد من خلال القانون الإطار 51.17 5، والتي وُصفت صراحة بأنها “رؤية استشرافية ومبتكرة” حتى قبل جائحة كوفيد-19، تكشف عن موقف استباقي واستراتيجي من قبل وزارة التربية الوطنية المغربية تجاه التحول الرقمي. هذا ليس مجرد إجراء رد فعل، بل هو جهد متعمد للاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز جودة التعليم وإمكانية الوصول إليه. هذا التوجه الرقمي الاستراتيجي يهدف إلى سد الفجوات الجغرافية، وتعزيز مرونة التعلم، وإعداد الطلاب لمستقبل يعتمد على التكنولوجيا. ومع ذلك، سيعتمد نجاحه بشكل كبير على توفر الوصول العادل إلى التكنولوجيا والبنية التحتية للإنترنت في جميع المناطق، بالإضافة إلى التدريب الكافي للمعلمين لاستخدام هذه الأدوات الجديدة بفعالية.
3. أهداف التعليم الأولي
3.1. الأهداف العامة (أفق 2028):
يُصنف التعليم الأولي كمشروع ذي أولوية قصوى وركيزة أساسية في المنظومة المدرسية المغربية، حيث تسعى الدولة جاهدة بالتعاون مع الشركاء إلى تعميمه بحلول عام 2028.9
- تيسير النمو الشامل للطفل: الهدف الأساسي هو تيسير النمو البدني والعقلي والوجداني الشامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 سنوات.2 تُعتبر هذه المرحلة حاسمة لتنمية الطفل بشكل عام.
- تعزيز الاستقلالية والتنشئة الاجتماعية: يهدف التعليم الأولي إلى مساعدة الأطفال على تحقيق الاستقلالية وتعزيز تنشئتهم الاجتماعية، وإعدادهم للتفاعلات الجماعية وبيئات التعلم المنظمة.2
- إعداد الأطفال للانتقال الناجح إلى التعليم الابتدائي: صُممت هذه المرحلة خصيصًا لإعداد الأطفال للانتقال بنجاح إلى السلك الأول من التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي) من خلال تعريفهم بالمعارف الأولية، والأرقام، والحروف، ومهارات الكتابة الأساسية.9
3.2. مخرجات التعلم المحددة:
- الأسس الدينية والأخلاقية المبكرة: تشمل الأهداف تعلم عدد محدد من الآيات القرآنية والمبادئ الأساسية للتربية الإسلامية.9 يتضمن ذلك أيضًا غرس القيم الوطنية والأخلاقية التي تُعد أساسًا للهوية المغربية.2
- تنمية المهارات الأساسية: يُتوقع من الأطفال اكتساب عادات تربوية أساسية، وتنمية مفاهيم التنظيم المكاني والتوجيه، وتعزيز قدراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعبيرية. كما تُعد تنمية التخصصات اليدوية هدفًا رئيسيًا.2
- التعريف باللغات المتعددة: يُقدم المنهج ثلاث لغات (العربية، والأمازيغية، واللغات الأجنبية) للأطفال من خلال أنشطة جذابة ومناسبة لأعمارهم مثل الأناشيد، والمسرحيات، والألعاب التربوية.10 يهدف هذا التعرض المبكر إلى بناء أساس لغوي قوي.
3.3. الدور في تحقيق جودة التعليم الشاملة:
يُصنف التعليم الأولي صراحة على أنه “مفتاح تحقيق جودة التعليم” و”رافعة لتطويره” في المغرب.9 هذا يُبرز أهميته الاستراتيجية في أجندة الإصلاح التعليمي الأوسع. تلعب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي دورًا حيويًا في هذا الجهد من خلال تطوير المناهج، وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، وتقديم برامج دعم مالي للأسر ذات الدخل المحدود لتشجيع التسجيل.9
يُظهر التركيز القوي على تعميم التعليم الأولي بحلول عام 2028 9، ووصفه صراحة بأنه “مفتاح تحقيق جودة التعليم” و”رافعة لتطويره” 9، فهمًا استراتيجيًا بأن تنمية الطفولة المبكرة هي أساس جودة التعليم الشاملة، وإجراءً استباقيًا للحد من معدلات الهدر المدرسي وصعوبات التعلم في المستقبل. هذا يعني أن الاستثمار في التعليم الأولي عالي الجودة يُنظر إليه على أنه استراتيجية فعالة للغاية وربما فعالة من حيث التكلفة لتحسين مخرجات التعليم بشكل عام، وتقليل عدم المساواة، وضمان استعداد أفضل للمدرسة الابتدائية، وبالتالي التخفيف من التحديات الأكاديمية المستقبلية ومعدلات التسرب.
إن الإدخال المبكر للمبادئ الإسلامية والقيم الوطنية، والتعرض المتزامن للغات العربية والأمازيغية والأجنبية في التعليم الأولي 2، يُبرز استراتيجية متعمدة لترسيخ الهوية الثقافية، والأسس الدينية، والتعدد اللغوي منذ بداية المسار التعليمي للطفل. هذا نهج استباقي لبناء الهوية الثقافية واللغوية، ويهدف إلى تنشئة شعور قوي بالانتماء مع إعداد الأطفال لعالم متنوع. يهدف هذا النهج الشامل إلى تنشئة مواطنين ليسوا فقط متعددي اللغات، بل أيضًا مرتبطين بعمق بتراثهم الوطني والديني. ويسعى إلى منع أي فجوات ثقافية أو لغوية محتملة في وقت لاحق من الحياة، وتعزيز مجتمع متناغم ومتعدد الثقافات يقدر مكوناته الثقافية المتنوعة.
4. أهداف التعليم الابتدائي (من الصف الأول إلى السادس) حسب المجال
4.1. الأهداف المعرفية:
- اكتساب وبناء المعارف الأساسية: يركز المنهج على اكتساب المعارف الأساسية عبر مختلف المواد الدراسية، مما يضمن أساسًا أكاديميًا متينًا.1 يشمل ذلك فهم المفاهيم والمبادئ الأساسية في مواد مثل الاجتماعيات (التاريخ، الجغرافيا، التربية المدنية).11
- تنمية التفكير النقدي والتحليل المنطقي: يهدف المنهج بشكل رئيسي إلى تعزيز استخدام العقل، والتفكير النقدي، والمبادرة، والابتكار، والإبداع.1 يُشجع الطلاب على تحليل المشكلات، واستنتاج الأفكار الرئيسية من النصوص، وتوليف المعلومات لتكوين فهم متماسك.12
- إتقان اللغات وأشكال الخطاب المتنوعة: يُعد إتقان اللغة العربية الفصحى هدفًا أساسيًا، إلى جانب تخصيص حيز مناسب للغة الأمازيغية وإتقان اللغات الأجنبية.1 يُتوقع من الطلاب إتقان مختلف أنواع التواصل داخل المؤسسة التعليمية وخارجها في مختلف مجالات تعلم المواد الدراسية، وفهم وإنتاج أشكال الخطاب المتنوعة (الأدبي، العلمي، الفني).7
- مهارات حل المشكلات: يهدف المنهج إلى تنمية قدرة الطلاب على استخدام الطريقة العلمية في حل المشكلات وتنمية التفكير الرياضي المنطقي.13
4.2. الأهداف المهارية:
- تطبيق المعرفة: يُتوقع من الطلاب تطبيق المفاهيم المكتسبة في مواقف جديدة وعملية.12 يشمل ذلك مهارات عملية مثل استخدام أدوات محددة (مثل المجهر) أو أداء إجراءات بشكل صحيح (مثل قياس الوزن، أداء العبادات بدقة).12
- التواصل والتعبير: تنمية التواصل السلس واليسير باللغة العربية الفصحى ومهارات التواصل الوظيفي الفعال.8 يجب أن يكون الطلاب قادرين على إنتاج نصوص حوارية بسيطة والتعبير عن أنفسهم بوضوح.14
- مهارات التنظيم والعمل: اكتساب منهجية التفكير والعمل بفعالية داخل الفصل وخارجه، وتنمية مهارات إدارة الذات.15 يشمل ذلك أيضًا التخطيط وتنظيم الأنشطة.13
- المبادرة والابتكار والإبداع: يُعد تعزيز هذه السمات لدى الطلاب هدفًا أساسيًا.1 تتضمن الأمثلة تشجيع الطلاب على ابتكار طرق جديدة لحل المشكلات أو تصميم وسائل تعليمية مبتكرة.13
- الكفايات التكنولوجية: تنمية القدرة على تصور وتصميم وإنتاج المنتجات التقنية، وإتقان الأدوات اللازمة لتطوير المنتجات.15 يتماشى هذا مع التوجه الأوسع نحو التحول الرقمي.
- تنمية المهارات الحياتية: دمج المهارات الحياتية الأساسية مثل الثقافة المالية، والسلامة الطرقية، وريادة الأعمال في المنهج الدراسي.16 تُعرف هذه المهارات بأنها مجموعة شاملة من الاستعدادات والقيم والمواقف التي تمكن الأفراد من مواجهة التحديات اليومية بفعالية وسلامة، وتحقيق النجاح في المدرسة والعمل والحياة المجتمعية.16
4.3. الأهداف القيمية:
- الهوية الوطنية وحب الوطن: تعميق الهوية الحضارية المغربية، وتعزيز الوعي بتنوع مكوناتها الثقافية، وغرس حب عميق للوطن والرغبة القوية في خدمته.1
- المواطنة والممارسات الديمقراطية: تعزيز قيم المواطنة المسؤولة، والانضباط، والمشاركة النشطة في الممارسات الديمقراطية.1 يشمل ذلك تشجيع الطلاب على المشاركة في وضع قواعد وضوابط للعمل الجماعي داخل البيئة المدرسية، مثل صياغة ميثاق القسم والمشاركة في تعاونية القسم.17
- احترام التنوع والآخر: تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الاجتماعي، وتشجيع احترام الآخر، وتنمية مهارات حل النزاعات سلميًا وإدارة الاختلاف، مع الرفض الصريح لجميع أشكال العنف.7
- القيم الأخلاقية والدينية: الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية الفاضلة.8
- المسؤولية البيئية: غرس احترام البيئة الطبيعية وتعزيز التعامل الإيجابي مع الثقافة الشعبية والتراث الثقافي والحضاري المغربي.7
- قيم التنمية الشخصية: بناء الثقة بالنفس، وتعزيز الانفتاح على الآخر، وتشجيع الاستقلالية في التفكير والممارسة، وتعزيز التنافسية الإيجابية، وغرس الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في المدرسة والحياة.1
يشير التركيز المتكرر على “الكفايات” والهدف الصريح لتطبيق المعرفة في “مواقف جديدة” و”سيناريوهات واقعية” 8 إلى تحول متعمد من التعلم القائم على الحفظ إلى منهج أكثر عملية وتطبيقًا. هذا يعني أن المنهج يهدف إلى أن لا يكتسب الطلاب الحقائق فحسب، بل أن يستخدموها بفعالية، مما يعزز التفكير النقدي، وحل المشكلات، والإبداع، وهي مهارات أساسية للقرن الحادي والعشرين. هذا التحول البيداغوجي يهدف إلى إعداد الخريجين بشكل جيد لتعقيدات الحياة الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتطور بسرعة، حيث تُقدر القدرة على تطبيق المعرفة والتفكير النقدي والابتكار بشكل كبير.
إن دمج “المهارات الحياتية” 16 و”السلوك المدني” 17 عبر مختلف المواد الدراسية، بدلاً من تدريسها كمواضيع منفصلة، يكشف عن استراتيجية متعمدة لترسيخ هذه الجوانب الحاسمة في تجربة التعلم اليومية. هذا يشير إلى أن القيم، والمهارات العملية، والكفايات الاجتماعية تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من التنمية الشاملة للمتعلم، وليست دروسًا معزولة. هذا النهج المتكامل يهدف إلى تعزيز تنمية أكثر طبيعية ومتسقة للقيم والمهارات العملية، مما يجعلها أكثر صلة بحياة الطلاب اليومية. ويعكس هذا إدراكًا بأن التعليم يجب أن يُعد الأفراد للحياة، وليس فقط للامتحانات، مما يساهم في بناء أفراد أكثر مرونة ومجتمع أكثر تماسكًا.
5. مكونات المناهج والأهداف المحددة
5.1. التربية الإسلامية:
تُعد التربية الإسلامية مكونًا أساسيًا في المنهج الابتدائي المغربي، بدءًا من التعليم الأولي.2 تشمل أهدافها:
- تعلم عدد محدد من الآيات القرآنية والمبادئ الأساسية للتربية الإسلامية.9
- غرس القيم الدينية والأخلاقية التي تتماشى مع التعاليم الإسلامية.2
- المساهمة في بناء شخصية متجذرة أخلاقياً.
5.2. الاجتماعيات (التاريخ، الجغرافيا، التربية المدنية):
الأهداف العامة: تهدف مادة الاجتماعيات إلى المساهمة في تكوين شخصية المتعلم بجميع أبعادها المعرفية والمهارية والوجدانية، لجعله فردًا يتفاعل إيجابًا مع محيطه.17 تسعى إلى تعميق الوعي بالسلوك المدني وربط مخرجات التعليم بالممارسات الحياتية والاجتماعية.17 تتكون المادة من التاريخ، والجغرافيا، والتربية المدنية.10
أهداف مادة التاريخ:
- معرفية: فهم مفاهيم الزمن والمكان؛ فهم الظواهر الطبيعية والبشرية والاقتصادية.17 تشمل أهداف الصف الخامس الابتدائي تحديد التاريخ، وعناصر الخريطة، وموقع المغرب وحدوده، ووصف التضاريس، ومعرفة العصور ما قبل التاريخية والتاريخية.11
- مهارية: قراءة وتفسير الخرائط؛ تحليل الأحداث التاريخية (تحديد الموضوع، اكتشاف الأحداث، جمع وفرز الوثائق، تفسير وتوثيق الحقائق)؛ تمثيل الأحداث على خط زمني؛ اكتشاف الماضي من خلال الشهادات الشفوية والوثائق المكتوبة؛ تحليل المكتشفات الأثرية.11
- قيمية: فهم أهمية التاريخ للتخطيط للحاضر والمستقبل؛ تقدير التراث الثقافي (الآثار الثابتة والمتحركة، التراث اللامادي).11
أهداف مادة الجغرافيا:
- معرفية: فهم عناصر الخريطة، والموقع الجغرافي للمغرب وحدوده، والتمييز بين أشكال التضاريس (السهول، الهضاب، الجبال)، وفهم مكونات المناخ، وتحديد خصائص المجال الريفي والحضري، وفهم التوزيع السكاني.11
- مهارية: استخدام مقاييس مختلفة (الفصل، الحي)؛ قراءة خطوط التسوية؛ ملاحظة ووصف الظواهر الجغرافية؛ دراسة القضايا البيئية.11
- قيمية: تقدير تنوع جغرافية الوطن؛ إدراك أهمية الموارد الطبيعية.11
أهداف مادة التربية المدنية:
- معرفية: تعريف الحقوق والواجبات والمسؤوليات؛ فهم ميثاق القسم؛ فهم مبادئ التنظيم؛ معرفة الديمقراطية المحلية (المجلس الجماعي).11
- مهارية: المشاركة في وضع قواعد القسم؛ انتخاب مجلس القسم؛ تنظيم العمل الشخصي؛ احترام الآخرين؛ إدارة الاختلافات والنزاعات سلميًا؛ رفض العنف؛ حماية الحياة الخاصة (خاصة عبر الإنترنت)؛ التعبير عن الآراء؛ تحليل المنتجات الإعلامية.11
- قيمية: تبني مبادئ المساواة بين الجنسين؛ الحفاظ على ممتلكات القسم والمرافق العمومية؛ الحفاظ على الصحة والسلامة الجسدية؛ الالتزام بالقوانين؛ احترام آراء الآخرين؛ تعزيز السلوك المدني الإيجابي.11
الجدول 1: أهداف مادة الاجتماعيات (الصف الخامس والسادس)
| البعد | التاريخ (الصف الخامس والسادس) | الجغرافيا (الصف الخامس والسادس) | التربية المدنية (الصف الخامس والسادس) |
| المعرفي | – فهم مفاهيم الزمن والمكان.17 <br> – معرفة العصور ما قبل التاريخية والتاريخية.11 <br> – فهم الظواهر الطبيعية والبشرية والاقتصادية.17 | – فهم عناصر الخريطة والموقع الجغرافي للمغرب.11 <br> – التمييز بين أشكال التضاريس (سهول، هضاب، جبال).11 <br> – فهم مكونات المناخ والتوزيع السكاني.11 | – تعريف الحقوق والواجبات والمسؤوليات.11 <br> – فهم ميثاق القسم ومبادئ التنظيم.11 <br> – معرفة الديمقراطية المحلية (المجلس الجماعي).11 |
| المهاري | – قراءة وتفسير الخرائط.11 <br> – تحليل الأحداث التاريخية (تحديد، اكتشاف، جمع، تفسير).11 <br> – تمثيل الأحداث على خط زمني.11 <br> – اكتشاف الماضي عبر الشهادات والوثائق.11 | – استخدام مقاييس مختلفة.11 <br> – قراءة خطوط التسوية.11 <br> – ملاحظة ووصف الظواهر الجغرافية.11 <br> – دراسة القضايا البيئية.11 | – المشاركة في وضع قواعد القسم وانتخاب مجلسه.17 <br> – إدارة العمل الشخصي وحماية الحياة الخاصة (خاصة عبر الإنترنت).11 <br> – إدارة الاختلافات والنزاعات سلميًا ونبذ العنف.17 <br> – التعبير عن الآراء وتحليل المنتجات الإعلامية.11 |
| القيمي | – فهم أهمية التاريخ للحاضر والمستقبل.11 <br> – تقدير التراث الثقافي والحضاري.11 | – تقدير تنوع جغرافية الوطن.11 <br> – إدراك أهمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.11 | – تبني مبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين.17 <br> – الحفاظ على ممتلكات القسم والمرافق العامة.17 <br> – الالتزام بالقوانين واحترام آراء الآخرين.11 <br> – تعزيز السلوك المدني الإيجابي.17 |
5.3. التربية الفنية والبدنية:
تُعد هذه المواد جزءًا لا يتجزأ من المنهج الابتدائي، وتهدف إلى تعزيز:
- التعبير الإبداعي من خلال مختلف الوسائط الفنية (الرسم، الموسيقى، الأناشيد، المسرح).10
- الرفاه البدني، والصحة، والروح الرياضية.10
- تنمية العمل الجماعي، والانضباط، والتعبير عن الذات من خلال الأنشطة البدنية.
5.4. تنمية المهارات الحياتية:
التعريف: تُعرف المهارات الحياتية بشكل عام بأنها مجموعة شاملة من الاستعدادات والقيم والمواقف التي يمكن تنميتها مدى الحياة. وتمكن هذه المهارات الأفراد من مواجهة التحديات اليومية بفعالية وسلامة، وتحقيق النجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والمجتمعية.16 وهي حاسمة لتعزيز المرونة والقدرة على التكيف في بيئة عالمية ورقمية معقدة.16
الدمج: لا تُدرس هذه المهارات بمعزل عن غيرها، بل تُدمج عبر المنهج الابتدائي، مما يضمن أهميتها العملية.16
أهداف المهارات الحياتية حسب الأبعاد: تُصنف أهداف المهارات الحياتية إلى أربعة أبعاد رئيسية:
- البعد المعرفي: يهدف إلى تزويد المتعلم بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بثقافة السلامة الطرقية، والثقافة المالية والضريبية، وريادة الأعمال، والانفتاح على عالم المهن والمشاريع الشخصية. كما يسعى إلى تصحيح أي تصورات خاطئة قد تكون لدى الطلاب حول هذه المواضيع.16
- البعد المهاري: يركز على مساعدة المتعلم على تنمية مهارات حياتية متنوعة وتدريبهم على تطبيق استراتيجيات التفكير النقدي وحل المشكلات (مثل “العادات الست عشرة للعقل”). ويؤكد على أهمية العمل، والمثابرة، والتعاون، والمنافسة الصحية، والمبادرة، والفعالية في اتخاذ القرار. ويُعد تمكين المتعلم من ربط التعلم الأكاديمي بالمهارات الحياتية هدفًا أساسيًا.16
- البعد الفردي: يهدف إلى تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس لدى المتعلم، وتشجيع السلوكيات والمواقف الإيجابية في إدارة ممارساتهم الحياتية المختلفة بأمان وإنتاجية. كما يُعدهم ليصبحوا مواطنين فاعلين ومسؤولين، ويغرس فيهم الوعي بالحفاظ على الموارد، والنزاهة، والمسؤولية. ويُعرفهم أيضًا بالتوجه نحو المسارات الأكاديمية والمهنية.16
- البعد الاجتماعي: يسعى إلى إعداد المتعلمين ليكونوا قادرين على التمييز بين السلوكيات والمواقف الإيجابية والسلبية في السياقات الاجتماعية، وتنمية مهارات العيش المشترك، ومساعدتهم على بناء علاقات اجتماعية قائمة على التواصل، والتعاطف، وقبول الاختلاف والتنوع، والمشاركة النشطة. ويهدف في النهاية إلى تزويد الأفراد منذ المراحل المبكرة من حياتهم بالكفايات اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية الحالية والمستقبلية.16
الجدول 2: أهداف المهارات الحياتية (الأبعاد المعرفية، المهارية، الفردية، الاجتماعية)
| البعد | الأهداف المحددة |
| المعرفي | – تزويد المتعلم بالمفاهيم الأساسية لثقافة السلامة الطرقية، والثقافة المالية والضريبية، وريادة الأعمال، وعالم المهن والمشاريع الشخصية. <br> – تصحيح تصورات المتعلمين حول المهن والمقاولات والضرائب.16 |
| المهاري | – مساعدة المتعلم على تنمية مهارات حياتية متنوعة وتدريبهم على تطبيق عادات العقل الست عشرة. <br> – توعية المتعلم بأهمية العمل، والمثابرة، والتعاون، والمنافسة الصحية، والمبادرة، والفعالية في اتخاذ القرار. <br> – تمكين المتعلم من ربط التعلمات الأكاديمية بالمهارات الحياتية.16 |
| الفردي | – توعية المتعلم وامتلاكه لسلوكيات ومواقف إيجابية في تدبير ممارساته الحياتية بأمان وإنتاجية. <br> – تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس لدى المتعلم وإعداده ليكون مواطنًا فاعلًا ومسؤولًا. <br> – غرس الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد والنزاهة والمسؤولية.16 |
| الاجتماعي | – إعداد المتعلم للتمييز بين السلوكيات والمواقف الإيجابية والسلبية في السياقات الاجتماعية. <br> – تنمية مهارات العيش المشترك وبناء علاقات اجتماعية قائمة على التواصل والتعاطف وقبول الاختلاف والمشاركة. <br> – تزويد الأفراد بالكفايات اللازمة لمواجهة التحديات المجتمعية الحالية والمستقبلية.16 |
6. استراتيجيات التنفيذ والتحديات
آليات تكييف المناهج وتكوين المعلمين:
تصدر وزارة التربية الوطنية بانتظام نسخًا محدثة من المناهج الدراسية، مثل المنهج المنقح للتعليم الابتدائي للعام الدراسي 2021/2022، وتفرض اعتمادها من خلال مذكرات رسمية.18 يُولى اهتمام كبير للتنمية المهنية المستمرة للمعلمين لتجديد وتعزيز كفاياتهم التربوية والمهنية، مما يضمن تأهيلهم لتطبيق المناهج الجديدة بفعالية.19 تلعب المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي دورًا حاسمًا في تطوير المناهج وتوفير التدريب المستمر للمعلمين، لا سيما في قطاع التعليم الأولي.9
معالجة التحديات:
- معدلات الهدر المدرسي: من الأهداف الإصلاحية الأساسية خفض معدلات الهدر المدرسي بمقدار الثلث، مع الإقرار بأن أكثر من 300,000 طفل وشاب يغادرون مقاعد الدراسة سنويًا.1 هذا يسلط الضوء على تحدٍ مستمر في استبقاء الطلاب.
- جودة مخرجات التعلم: على الرغم من إصلاحات المناهج، لا يزال هناك تحدٍ كبير في تحسين جودة مخرجات التعلم. الهدف هو زيادة معدل تمكن المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70% من المعدل الحالي البالغ 30% 1، مما يشير إلى فجوة كبيرة بين الأداء الحالي والمستويات المرجوة.
- الولوج العادل وبيئة التعلم: يُعد ضمان بيئات وشروط تعلم مناسبة للمشاركة والنجاح هدفًا رئيسيًا، خاصة للطلاب في المناطق القروية وشبه الحضرية وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين غالبًا ما يواجهون تحديات أكبر.1
- دعم المعلمين والموارد: أُثيرت مخاوف بشأن الدعم العملي للمعلمين، بما في ذلك الحالات التي يُتوقع فيها منهم شراء حواسيبهم ووسائلهم التعليمية الخاصة. هناك حاجة مُعترف بها لدعم مالي كافٍ لأدوات العمل والعودة إلى جدول زمني معقول للحصص الأسبوعية.10
- ظروف الفصول الدراسية: لا تزال التحديات قائمة فيما يتعلق باكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص المرافق الكافية، والافتقار العام إلى الوسائل التعليمية المناسبة، مما قد يعيق تنفيذ المناهج بفعالية.10
دور المنصات الرقمية وأنظمة إدارة البيانات:
يُستخدم نظام المعلومات “مسار” لرقمنة البيانات المجمعة من المدارس، بهدف تعزيز القدرات الإدارية، وتتبع تقدم الطلاب، وتحسين المساءلة على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.9 يجري إنشاء نظام لتقييم المشاريع المدرسية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد التتبع، إلى جانب أنظمة التقييم الإقليمية والجهوية.9 تُشير مأسسة التعليم عن بعد من خلال القانون الإطار 51.17 إلى تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتعليم التكميلي، مما يتطلب بنية تحتية تكنولوجية قوية.5
على الرغم من أن السياسات التعليمية المغربية تحدد أهدافًا طموحة لتحسين الجودة وتعميم التعليم 1، إلا أن المعطيات تُظهر تحديات عملية كبيرة. التباين الصارخ بين الهدف البالغ 70% في إتقان الكفايات الأساسية والمعدل الحالي البالغ 30% 1، إلى جانب المخاوف بشأن موارد المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية 10، يُشير إلى فجوة كبيرة في التنفيذ. هذا يعني أن القضايا النظامية المتعلقة بالتمويل والبنية التحتية ودعم المعلمين تُعد عقبات حاسمة تعيق التحقيق الكامل لأهداف السياسة.
إن الإشارة الصريحة إلى رقمنة البيانات من خلال نظام “مسار” وإنشاء آليات تقييم إقليمية وجهوية 9 تُشير إلى توجه استراتيجي نحو حكامة تعليمية قائمة على البيانات. هذا يدل على محاولة استباقية لتعزيز الشفافية، وتتبع التقدم بشكل منهجي، وتحديد مجالات الضعف، وربط المسؤولية بالمساءلة عبر الإدارة التعليمية. هذا التوجه نحو الحكامة القائمة على البيانات لديه القدرة على أن يؤدي إلى تدخلات أكثر استهدافًا، وتخصيص أفضل للموارد بناءً على الاحتياجات المحددة، وتحسين الكفاءة الشاملة للنظام. ومع ذلك، ستعتمد فعاليته على موثوقية جمع البيانات، والقدرة التحليلية للمسؤولين التربويين، والرغبة في التصرف بناءً على المعلومات المستخلصة من هذه البيانات.
7. الخلاصة والتوصيات
ملخص النتائج الرئيسية:
- يُوجه نظام التعليم الابتدائي في المغرب بقوة من خلال إصلاحات وطنية طموحة، أبرزها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17. تُحدد هذه الإصلاحات مجموعة شاملة من الأهداف التي تركز على التنمية الشاملة للمتعلم، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان تعليم عالي الجودة للجميع.
- يُعترف بالتعليم الأولي استراتيجيًا كمرحلة تأسيسية حاسمة، مع أهداف واضحة تركز على تنمية الطفولة المبكرة، والاستعداد للمدرسة، والتنشئة المبكرة للهوية الوطنية والتعدد اللغوي.
- تُعد أهداف التعليم الابتدائي متعددة الأوجه، وتشمل الإتقان المعرفي، وتنمية المهارات العملية والعرضية (بما في ذلك المهارات الحياتية الأساسية)، وترسيخ القيم الجوهرية. هناك تركيز قوي على تعزيز الهوية الوطنية، والمواطنة المسؤولة، والتفكير النقدي، والإبداع، والقدرة على التكيف.
- ينتقل المنهج بنشاط نحو مقاربة قائمة على الكفايات، مع إعطاء الأولوية لتطبيق المعرفة وأهميتها في سيناريوهات العالم الحقيقي.
- بينما الإطار السياساتي قوي واستشرافي، يواجه التنفيذ تحديات كبيرة، بما في ذلك معدلات الهدر المدرسي المستمرة، والفجوة بين مخرجات التعلم المستهدفة والفعلية، والحاجة إلى تعزيز دعم المعلمين والتوزيع العادل للموارد.
توصيات للتحسين المستمر:
إعطاء الأولوية للبحث والتقييم التكيفي: إجراء بحث وتقييم مستمرين ودقيقين لتقييم فعالية الإصلاحات المنفذة. يجب أن تُستخدم هذه الأدلة التجريبية لتوجيه التكيف المستمر وصقل الاستراتيجيات لضمان بقاء نظام التعليم مستجيبًا للاحتياجات الوطنية المتطورة والتحديات العالمية.
تعزيز تمكين المعلمين والموارد: من الضروري توفير دعم شامل للمعلمين، بما في ذلك الموارد التعليمية الكافية، والتنمية المهنية المستمرة المتوافقة مع المقاربات البيداغوجية الجديدة، والحوافز المالية المناسبة. تُعد معالجة المخاوف بشأن الاستثمار الشخصي للمعلمين في اللوازم المدرسية 10 أمرًا حيويًا لضمان تسليم المناهج بفعالية.
سد الفجوة بين السياسة والممارسة: تطوير استراتيجيات مستهدفة وتخصيص موارد كافية لترجمة أهداف السياسة الطموحة إلى تحسينات ملموسة في مخرجات التعلم. يشمل ذلك التدخلات المركزة لخفض معدلات الهدر المدرسي وزيادة إتقان الطلاب للكفايات الأساسية بشكل كبير.1
ضمان الاندماج الرقمي العادل: مع مأسسة التعليم عن بعد، من الضروري ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا الموثوقة والبنية التحتية للإنترنت في جميع المناطق، لا سيما في المناطق القروية المحرومة. هذا سيمنع تفاقم الفجوات الرقمية القائمة ويضمن استفادة جميع المتعلمين من التطورات التكنولوجية.
تعزيز الرصد والمساءلة القائمين على البيانات: الاستفادة الكاملة من البيانات من أنظمة مثل “مسار” 9 لرصد التقدم باستمرار، وتحديد مجالات التحسين المحددة، وضمان آليات مساءلة قوية على جميع مستويات الإدارة التعليمية. سيمكن هذا من إجراء تعديلات سياساتية أكثر مرونة واستنادًا إلى الأدلة.
تعزيز مشاركة الفاعلين النشطة: تشجيع وتسهيل المشاركة النشطة من قبل أولياء الأمور والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم الأهداف التعليمية. تُعد مشاركتهم حاسمة بشكل خاص لنجاح التعليم الأولي وفي خلق نظام بيئي داعم للتعلم.3